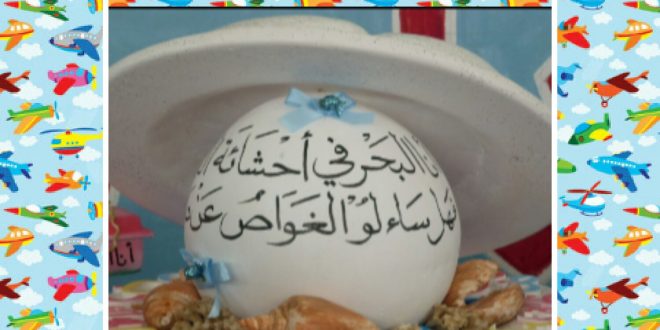إعداد طالبة الماستر 2ليلى محمد سعيد
تدقيق البحث ومعالجة الأخطاء
تمهيد
تعدّ مرحلة كتابة البحث مفصليّة ومهمّة، فهي المرحلة التي تتحوّل فيها الأفكار والمعلومات المتناثرة والموزّعة على البطاقات إلى سلسلة متماسكة ومبوّبة.
وهذا الأمر يتطلّب من الباحث أن يكتب كتابة سليمة بأسلوب واضح وسلس حتى ينجح في إيصال أفكاره إلى القارئ من دون أن يتكنّفها الغموض أو الضعف أو الركاكة؛ ولأنّه أثناء كتابته الأولى يكون مشغولًا بتتبّع أفكاره أو مناقشة رأي أو عرض مسألة فإنّه قد يغفل عن كثير من قواعد اللغة، أو يقع في أخطاء بالأسلوب أو التركيب، ما يلزمه بعد صياغة كلّ فصل أو باب أو حتى البحث كلّه بقراءته بتمعّن وتأمّل ومراجعته؛ بغية تصحيح الأخطاء أو تدارك ما فاته من تحسين أسلوبه[1].
وهنا يفضّل أن يكون الباحث هو نفسه المراجع والمدقّق اللغويّ[2]، وفي حال لم يجد نفسه متمكّنًا من ذلك يمكنه إحالة بحثه إلى مدقّق لغويّ متخصّص، ولكن هذا لا يعفيه من مراجعته بنفسه أوّلًا، لتتبّع النقص وإيجاد الثغرات، والكلمات التي تحتاج إلى توضيح أو شرح[3].
وما ينبغي للباحث في مرحلة المراجعة والتدقيق اللغويّ هو أن يمعن النظر في أسلوبه، ويتتبّع الأخطاء الإملائيّة، والنحويّة، والصرفيّة، والأخطاء اللغويّة (الشائعة والركيكة)، وهذه هي العناوين التي سنتناولها بشيء من التفصيل في الأبواب الآتية.
أوّلًا: الأسلوب
يعتمد إنجاح البحث على أسلوب الباحث الذي يتّبعه في عرض الأفكار، وتقديم المعلومات، وربط الفصول وتماسكها، فالأسلوب: «الوتر الدقيق القويّ الذي يستعمله الصائغ في جمع اللآلئ ليجعل منها عقدًا ثمينًا منتظمًا لا نشاز فيه ولا شائبة»[4].
وهو يرتكز على أمرين أساسيّين:
1- كثافة الأفكار وخصبها وعمقها.
2- انتقاء المفردات الموافقة لتأدية هذه الأفكار[5].
وثمّة جملة من الضوابط الأسلوبيّة التي ينصح الباحث بأن يتقيّد بها[6]، أو أن يلتفت إليها حين مراجعته رسالته؛ وهي:
– اختيار الألفاظ:
انتقاء الألفاظ المناسبة لبحثه وطبيعته، على أن تكون واضحة، وفي حال وجد الباحث نفسه أمام ألفاظ قد تحتمل أكثر من معنى، لا بدّ له من توضيح معناه المقصود، وقد يضطرّ إلى إعادة صياغة فكرة بألفاظ أخرى إن وجد داعيًا لذلك.
وعليه أن يبتعد عن الألفاظ الغريبة والمهجورة لأنّها قد تعقّد المعنى وتقلّل من التأثير في القارئ.
– العبارات:
عند مراجعته البحث، لا بدّ له من التأنّي في قراءة الجمل والعبارات التي كتبها، للتأكّد من أنّها على قدر تمام المعنى الذي يريد إيصاله[7]، فقد يكون أفاض في شرح قضيّة يفضّل إيجازها، أو أوجز فأخلّ بالعبارة ولا بدّ من إعادة صياغتها[8].
وعليه أيضًا أن يراجع مدى ترابط الجمل فيما بينها، وإذا ما وجد استطرادًا أو تكرارًا أو زخرفات لا طائل منها يعمد إلى تداركها والتخلّص منها.
ولا بدّ له من تجنّب الجمل الطويلة أكثر من اللازم، أو التي تحوي عناصر كثيرة، وألّا يباعد بين المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، ولا يكثر من الأفعال المبنيّة للمجهول[9].
– الفقرات:
أثناء كتاب البحث، يكون تركيز الباحث على صياغة الأفكار، وقد يتشتّت عن تسلسلها وتراتبها، لذا يجب عليه عند مراجعته أن يهتمّ بمدى تسلسل فقراته، وتماسكها حول فكرة ما، وتمييز الفقرات بسطر جديد وفراغ بين كلّ فقرتين.
– الجدال والأدلّة:
قد يجد الباحث في مراجعته أنّ دليله على مسألة ما يحتاج إلى الرجوع إلى مصدر ما غفل عنه، أو استشارة مختصّ، أو أخذ رأي آخر معتدّ به أكثر من رأيه (رأي المشرف مثلًا)، أو يرى أنّه بحاجة إلى الرجوع إلى معجم لغويّ أو علميّ[10].
ولا بدّ من مراعاة آداب البحث والمناظرة (التواضع العلميّ واحترام آراء الغير) عند إثارته مسألة فيها خلاف أو حولها جدال؛ وهو ما يلزمه بإعادة صياغة فكرته التي يكون قد كتبها مدافعًا عنها بشراسة دون مراعاة ذلك.
– الضمائر:
لأنّ الباحث يجتهد ويتعب في بحثه وعرض أفكاره، قد يلجأ إلى استعمال الضمائر التي توحي بالاعتداد بالنفس مثل: أنا ونحن، وهنا يستحسن الاستعاضة عنها بأسلوب علميّ مجرّد واستعمال ما هو عام مثل: يبدو أنّ، الرأي الغالب، لهذا..
ولا يستسيغ الباحث الألفة مع المؤلّفين كأن يشير إلى طه حسين بـ«طه»، أو أن يكثر التهكم، ويخاطب القارئ بشكل مباشر[11].
ولا بدّ من الحفاظ على الأسلوب الذي يختاره من بداية البحث حتى نهايته، لا أن يخلط بين أكثر من أسلوب بما يوهن البحث ويضعفه.
– الاقتباس:
يضطرّ الباحث في كثير من الأحيان إلى الاقتباس من مصادر ومراجع، تختلف أساليب كتّابها عن أسلوبه، لذا يكون الباحث أمام أمرين:
أ- إمّا أن ينقل حرفيًّا، وهكذا يميّز القارئ أنّ الأسلوب هنا هو لصاحب المصدر أو المرجع وليس للباحث.
ب- إمّا أن ينقل مضمون الفكرة بأسلوبه الذي اعتمده، على أن يشير في الهامش إلى مصدرها الأساسيّ، حفاظًا على الأمانة العلميّة.
ثانيًا: تتبع الأخطاء الإملائيّة
من آفات البحث إهمال حقل الإملاء، أو عدم العناية بسلامة الإملاء، إمّا عن تقصير ناتج من جهل بقواعد الإملاء، وإمّا عن غير قصد عندما يكون ذلك خطأ في الطباعة مثلًا، من هنا أهميّة مراجعة الباحث لما كتبه وتدقيقه لغويًّا، وما يجب أن يلتفت إليه في هذا الجانب، الأمور الآتية:
– تدوين الشدّات، فالشدّة هي في الأصل حرف ساكن دمج بمثيله المحرّك، واتخّذ هذا الشكل، لهذا صار من الضروريّ وضعه، وإلّا عدّ ذلك خطأ في الكتابة، فـ«شدّ» هو فعل من ثلاثة أحرف أصله شدْد.
– تدوين حركة التنوين، خاصّة عند النصب، على أن توضع الفتحتان على الحرف الذي يسبق الألف، وهي الكتابة الأصحّ، مثال: قرأت كتابًا.
– التمييز بين همزة الوصل وهمزة القطع.
– الإلمام بقواعد الهمزة المتوسطة وفي آخر الكلمة.
– التمييز بين الألف الطويلة والألف المقصورة.
– معرفة المواضع التي تحذف فيها بعض الأحرف المنطوقة.
– إضافة الأحرف التي تزاد كتابة لا نطقًا.
– معرفة موارد الوصل والفصل.
– موارد كسر همزة «إنّ» وفتحها.
– التمييز بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة في آخر الكلمة[12].
أمثلة تطبيقيّة لبعض القواعد الإملائيّة:
· حذف الألف من «ما » الاستفهاميّة إذا دخل عليها حرف جرّ ويعوّض منها بالفتحة، نحو: في + ما؟ = فيم؟
· زيادة الألف الفارقة بعد واو الجماعة، للتفريق بينها وبين واو العلّة من جهة، وبينها وبين واو جمع المذكّر السالم، نحو: هم قدموا/ الطفل يحبو/ معلّمو المدرسة.
· تكتب الألف طويلة في آخر الفعل الماضي الثلاثيّ إن كان أصلها واوًا، وتكتب مقصورة إن كان أصلها ياء، نحو: شكا/ يشكو، رمى/ يرمي.
· تكون الهمزة همزة وصل في: المصدر أو الاسم الذي يدلّ على الفعل الخماسيّ والسداسيّ، وماضيهما، نحو: استغفر، انتظار.
في أمر الفعل الماضي، نحو: ادرس.
في الأسماء: ابن، ابنة، اثنان، اثنتان، امرؤ، امرأة، اسم.
في «ال» التعريف.
· تكتب التاء مربوطة في: آواخر: الاسم المؤنث، الصفة المؤنثة، الاسم الذي ينتهي بتاء قبلها ألف نحو حصاة. وفي نهاية جمع التكسير، وصيغ المبالغة، وأسماء العلم المفردة المؤنّثة (لفظيًّا، معنويًّا).
· تكتب التاء طويلة عندما تكون أصليّة في الفعل أو الاسم، أو ضمير متّصل بالماضي، أو تاء التأنيث، في جمع المؤنث السالم، في آخر الاسم إذا سبقت بواو أو ياء ساكنة، نحو: بيروت، وفي نهاية الأسماء الأعجميّة أو الأجنبيّة، نحو: زرادشت[13].
ثالثًا: الأخطاء النحويّة
وهي الأسهل من بين الأخطاء التي يمكن تداركها في حال كان المدقّق متمكّنًا من قواعد النحو، ولا بدّ له أيضًا من الاطّلاع على الخلافات بين المدارس حتى لا يخطّئ ما قد يكون صوابًا في مدرسة نحويّة لا يتّبعها، وهذه بعض القواعد النحويّة التي يجب أن يعرفها ويفقهها الباحث، وخاصة عند تدقيقه بحثه:
– أنواع الجملة وأركانها.
– النواسخ وعملها.
– العلاقات الإسناديّة في الجملة.
– أدوات النصب والجزم.
– التوابع.
– أحوال الأفعال.
– الإعراب والبناء.
– الفاعل ونائبه.
– المفاعيل والمنصوبات الأخرى.
– أساليب: الاستثناء، التمييز، النداء، التعجّب، المدح والذم.
– العدد والمعدود.
– المجرورات وشبه الجملة.
ويمكنه الاستعانة بالكتب النحويّة التي تزخر بها المكتبة العربيّة.
رابعًا: الأخطاء الصرفيّة:
وهي أن يتحقّق الباحث من حسن استعماله الميزان الصرفيّ في كتابته، وأن يميّز بين مزيدات الفعل وتغيّر معانيها، وعليه أن يعلم كيفية تثنية الأسماء وجمعها وتأنيثها وتذكيرها، ومشتقّات الأسماء وغيرها ممّا أدرج في علم الصرف، نحو:
– المجرّد والمزيد.
– أوزان الافعال، صحيحها، معتلّها.
– الإعلال والإبدال.
– التصغير.
– النسبة.
ومن الكتب التي تفيد الباحث في الصرف: كتاب التطبيق الصرفيّ للدكتور عبده الراجحي.
خامسًا: الأخطاء الشائعة:
وهي عمدة ما يجب على الباحث أن يوليه عنايته؛ إذ تكمن خطورتها بتهديدها صميم اللغة العربيّة، فلا قواعد تحكمها؛ ما قد يؤدّي إلى اتساع رقعتها، لذا على الباحث أن يدقّق بالرجوع إلى دراسات اللغويّين وكتبهم التي ألّفوها وجمعوا فيها أهمّ الأخطاء الشائعة وصوّبوها، فإنّه من فساد اللغة العربيّة تطبيق القول السائد: «خطأ مشهور خير من صواب مهجور».
فهذه الأخطاء قد تكون في رسم الهمزة مثلًا على خلاف قاعدتها، إثبات نون الأفعال الخمسة في موارد حذفها عند النصب والجزم، أو العكس، تعدية الأفعال المتعدّية بنفسها إلى أحرف الجرّ، استبدال أحرف الجرّ أحدها مكان الآخر، استعمال كلمات في غير المعنى الذي وضعت له لتقارب المعاني، الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعطوف على الأوّل، إتباع الأسماء الموصولة تذكيرًا وتأنيثًا، إفرادًا وجمعًا لما يليها وليس لسابقها.
وثمّة أخطاء ترجع إلى عدم الإلمام بالميزان الصرفيّ، أو اعتماد كلمات ركيكة لها بديل أفصح.
بعض الكتب الحديثة التي جمعت الأخطاء الشائعة وصوّبتها:
– «معجم الأخطاء الشائعة»، و«معجم الأغلاط المعاصرة» لمحمّد العدناني.
– «معجم أخطاء الكتّاب» لصلاح الدين الزعبلاوي.
– «نحو إتقان الكتابة باللغة العربيّة» للدكتور مكّي الحسني.
– «معجم تصحيح لغة الإعلام العربيّ» للدكتور عبد الهادي بو طالب.
– «قل ولا تقل» (جزءان) للدكتور مصطفى جواد.
– «الأخطاء الشائعة في استعمالات حروف الجرّ» للدكتور محمود إسماعيل عمار.
ومن أمثلة الأخطاء الشائعة وتصويبها[14]:
الخطأ
الصواب
دعا لـ
دعا إلى
يتواجد في هذا المكان
يوجد في هذا المكان
بخّور
بخور( من دون الشدّة)
اعتذر عن الحضور
اعتذر عن عدم الحضور
سافر لوحده
سافر وحده
الماء المغلي
الماء المغلى
وهكذا، بعد أن يعالج الباحث أخطاءه ويدقّق بحثه، يستطيع تقديمه إلى مشرفه وهو بالجودة والمستوى اللائقين، فمهما كان الباحث متمكّنًا من اللغة فإنّه قد يقع عن غير قصد في بعض الهفوات، التي يمكن له تضييق دائرتها إذا ما اتّبع هذه الخطوات التي توصله إلى الكتابة الإبداعيّة التي تخلو أو تكاد تخلو من الأخطاء:
1- المطالعة الواسعة للكتب والمؤلفات والمعاجم والموسوعات، تطبيقًا للقول: «تلاقح العقول مصانع الرجال».
2- المطالعة الجادّة الملتزمة بالاستفادة من كلّ كلمة معبّرة أو جملة مؤثّرة أو صياغة راقية.
3- المطالعة الطويلة المستمرّة، فالعقل اللغويّ يتكوّن تدرّجًا وتدريجًا يومًا بعد يوم، والأفكار والمعارف والمعلومات تتراكم يومًا إثر يوم أيضًا.
4- المطالعة العميقة للأفكار (تأمّلًا- إنعامًا- إمعانًا) وسبر أغوار الكلام لاكتشاف الغايات والمغازي والأهداف القريبة والبعيدة.
5- المطالعة المستندة إلى الصبر والتأنّي، لمعرفة صيغ الكلام الأسلوبيّة، ودلالتها اللغويّة.
6- التدرّب على الكتابة، جملًا مختارة راقية المستوى الأدبيّ، وعبارات جميلة معبّرة، ومقالات محدّدة هادفة، بالإضافة إلى إعداد المؤلّفات المختلفة في حجمها ومضامينها وأنواعها الأدبيّة.
7- الاستعانة بالشواهد الشعريّة والنثريّة والتعابير الأدبيّة لتقوية المعاني.
8- اتّخاذ المعاجم والقواميس كتبًا للمطالعة المستمرّة لاستخراج دررها اللغويّة، وجواهرها التعبيريّة[15].
الخلاصة:
استعرضنا في هذا المبحث أهميّة التدقيق اللغويّ للبحث، وضرورة مراجعته من الباحث، وأن يركّز على أسلوبه ويتّتبع الأخطاء الإملائيّة، والنحويّة، والصرفيّة، والأخطاء اللغويّة.
وقلنا أنّ الأسلوب يرتكز على كثافة الأفكار وخصبها وعمقها، وانتقاء المفردات الموافقة لتأدية هذه الأفكار، ويجب فيه مراعاة بعض الضوابط التي تتعلّق باختيار الألفاظ والعبارات، وترتيب الفقرات، والتقليل من الجدال، واستعمال ما هو عامّ بدلًا من الضمائر التي توحي بالاعتداد بالنفس، وأن يحافظ على وحدة الأسلوب، ويحيل ما اقتبسه حرفيًّا أو بالمضمون إلى صاحبه.
وذكرنا أنواع الأخطاء التي يحتاج الباحث إلى تصحيحها، من إملائيّة سببها الإخلال بقواعد الإملاء، أو نحويّة سببها عدم الإلمام بالنحو، أو صرفيّة لعدم التمكّن من الميزان الصرفيّ.
وفي الأخطاء الشائعة ذكرنا بعض الكتب التي ألّفت فيها، وعرضنا أمثلة منها، وبيّنا أهميّة معالجتها لما تشكّله من خطر على اللغة العربيّة.
وفي الختام كان لا بدّ من ذكر بعض الخطوات التي تصل بكتابة الباحث إلى مستوى الإبداع.
 مجلة إشكاليات فكرية مجلة ثقافية معرفية
مجلة إشكاليات فكرية مجلة ثقافية معرفية